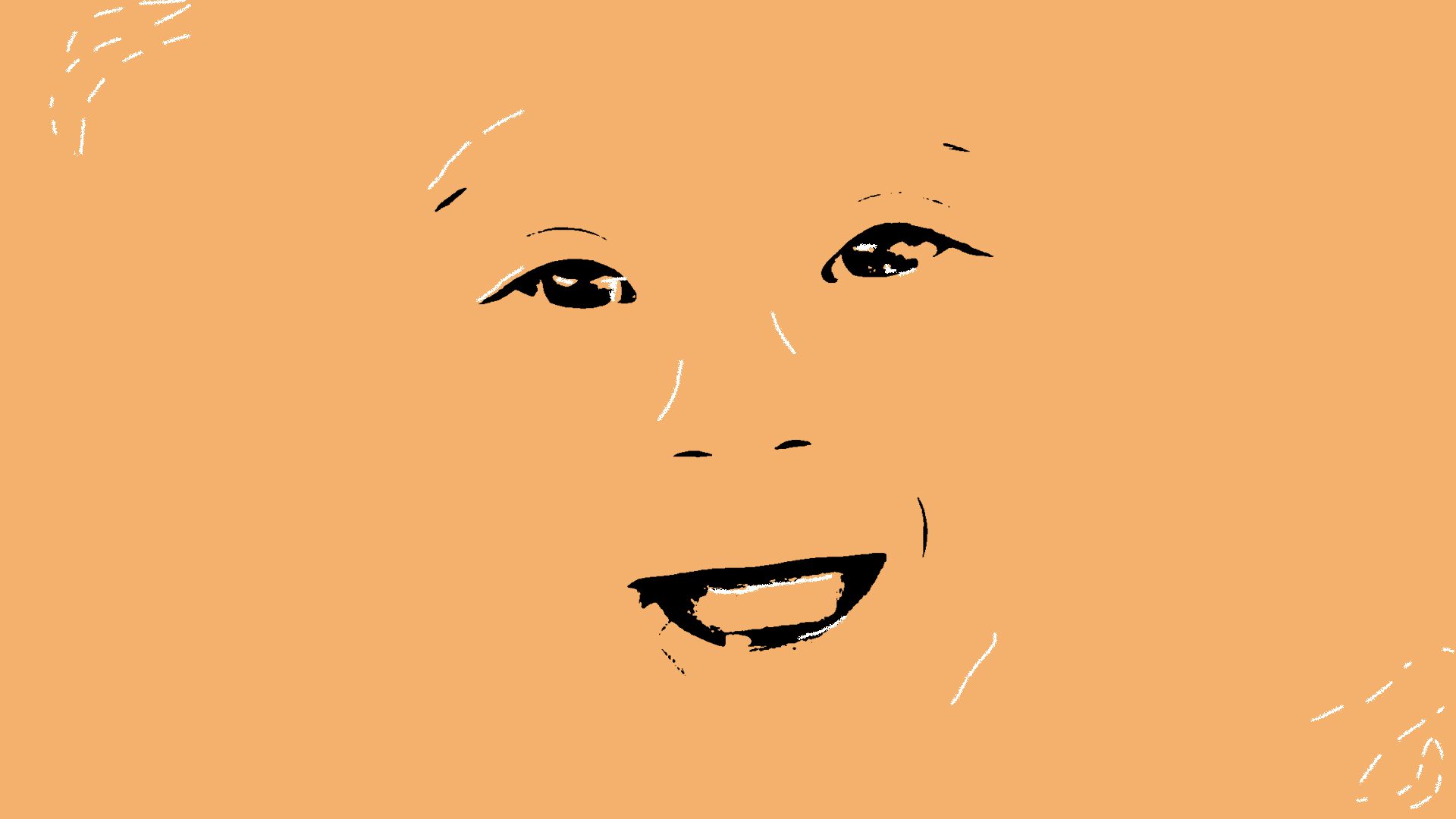“ليش يارب؟ شنو ذنبنا؟”
كان ذاك صوت أمي، يطرق أبواب السماء كل ليلة، يعاتب الرب والقدر لسنوات، وما فتئ يتردد في أذني منذ الخامس عشر من تشرين الثاني عام 2009 وحتى اليوم، بلا جواب.
كنت في الصف الخامس الابتدائي، عدتُ إلى منزلنا عصراً، أرتدي صدريتي النيلية وقميصي الأبيض، وأحمل حقيبتي بتثاقل، وملامحي متعبة بعد يوم دراسي طويل. كان كل شيء يبدو كالمعتاد، حتى تلقيتُ خبر أن أمي ولدت. في الغرفة، وجدتُ أمي مستلقية وبجوارها الطفل الجديد بعد أن كان في بيت القابلة، كان الصمت يملأ منزلنا، لا أحد بدا راضياً، صمت يختبئ خلفه شعور بالحزن والرفض.
كان والدَيّ يتأملان أن يولد “ولد” للعائلة، بعد ثلاث بنات، لكن مجدداً، تكرر القدر نفسه ” طفلة…بنت”.
كنتُ الابنة الكبرى في العائلة، لذا فقد تركتْ كل ولادات أمي أثراً عميقاً في ذاكرتي. هذه الولادة تحديداً ما برحت عالقة في ذاكرتي وذاكرة والديّ، اللذَين لم يخب أملهما من كونها أنثى فحسب، بل مما اكتشفاه لاحقاً.
في اليوم التالي للولادة، أخذ والدي الطفلة لإجراء بعض الفحوصات الروتينية، وهناك، اندهش الطبيب عند رؤيتها، والتفت لوالدي قائلاً: الأمر مؤسف، لكن يبدو أن الطفلة وُلدت بتركيبة جينية مختلفة تُعرف “بمتلازمة داون”، ناتجة عن خلل في الكروموسومات، مما يؤثر في نموها الجسدي والعقلي، وشرح له أن من لديه هذهِ المتلازمة تكون له ملامح خاصة وهيئة جسدية مختلفة، كما يواجه المصابون درجات متفاوتة من التأخر الإدراكي، وصعوبات في النطق والتعلم، وبطء النمو.
صُدم والدي عند سماعهِ ذلك، وتجمد في مكانهِ، وتبدلت ملامحه، وكأنه يحمل همّ العالم على كتفيهِ، بقي صامتاً مذهولاً، فلم يسبق لأحد من عائلتنا أو أجدادنا أن عانى من متلازمة مماثلة، مما يجعلها طفرة جينية غير موروثة في سلالة العائلة. كانت الولادة طبيعية، وكشف السونار أثناء فترة الحمل أن الجنين طبيعي، فضلاً عن أن شكلها وهي رضيعة يصعب تمييزه.
تكتم والدي على الخبر لأيام، محاولاً إخفاءه عن أمي، خوفاً عليها من الانهيار، ولكن الأمر لم يدم طويلاً، فعندما ذهبت أمي لاحقاً إلى المستشفى لإعطاء الطفلة اللقاحات المطلوبة، اقتربت منها إحدى الممرضات بالصدفة، وحدقت في وجه الطفلة بنظرات متشائمة، ثم قالت بصوت مندفع، وهجومي، وبلا رحمة أو تمهيد “هاي بنتج منغولية… مريضة”.
في تلك اللحظة، أغمي على والدتي من شدة الصدمة، ثم أصابتها نوبة من البكاء والإنكار، صُدمت نفسياً، وأمضت أياماً تبكي وتندب حظها، وتردد “ليش يا رب؟” كأنما تبحث عن إنصاف مفقود.
امتنعت أمي عن الإنجاب بعد ولادة فاطمة. لقد كانت تلك الفترة إحدى اسوأ الفترات في حياة العائلة، لم تكن طفولتي قادرة على استيعاب كل ما يحدث، لقد تمنوا أن تموت شقيقتي الصغيرة كي لا تكبر وهي بنت بمتلازمة داون في مجتمع لا يرحم.
كان حزن والديّ أعمق من أن يُقال، لأنهما كانا يريان أبعد مما نراه نحن الأطفال، كانا يفكران بالمستقبل، بالمدرسة التي لن تدخلها، وبالتخرج الذي لن نحتفل بهِ، وبالمجتمع الذي سيعاملها على أنها طفلة “مريضة” و”عاجزة” و”مسكينة”.
اليوم بعد مرور ستة عشر عاماً منذ ولادة فاطمة، قد لا يكون العالم قد تغير، ولا أصبحت الحياة مع متلازمة داون أسهل، لكني أختار أن أروي قصتها وقصتنا معها دون ندب، بل بحب واحترام لتجربتنا المميزة معها.
طفولة ملونة بصبغة خاصة
فاطمة باتت تنمو وتتحدد ملامحها وإمكانياتها الجسدية والعقلية مع الوقت.
ملامح وجهها بريئة ومسطّحة، عيناها لوزيتان مصحوبتان بطيّات جلدية داخلية تُعرف بـ”الطيات الموقية”، أنفها صغير مرسوم بعناية، وارتخاء واضح في عضلات الفم يجعل اللسان بارزاً قليلاً، وأذنان تبدوان أصغر من حجمهما الطبيعي. في راحة يدها خط وحيد بدلاً من الخطين المعتادين، مع مسافات أوسع بين أصابع القدم ولا سيما الإصبع الكبير والإصبع المجاور لهُ. رخاوة جسدها ونعومته تجعلها تبدو كالعجينة تماماً، لا تمتلك أدنى صلابة أو قوة في حركتها وتعجز عن تحريك جسدها بسهولة، وحتى زجاجة الحليب الخاصة بالأطفال لم تكن تتمكن من إمساكها دون مساعدة. جسدها بسهولة، فحتى زجاجة الحليب الخاصة بالأطفال لم تتمكن من امساكها دون مساعدة أحد.
حينما ولدت فاطمة، ولسنوات تلت، لم يكن والديّ يجهلان أعراض متلازمة داون فحسب، بل إنهما لم يكونا مؤهلين نفسياً وفكرياً للتعامل مع طفلة مصابة بهِ.
والدتي متعبة من تربيتها، تندب حظها، وتلاحقها المقارنة مع باقي النساء اللواتي كبر أطفالهن، يركضون، ويتحدثون، وفاطمة لا تكبر، فالوزن ذاته، والملامح ذاتها. كان الزمن يتغير، والأشخاص يتغيرون، وكل شيء يتغير حولي ما عداها، ما زالت على الهيئة نفسها، لا تؤثر فيها السنوات، لا تزيدها ولا تنقصها، عالقة هناك!
لوهلة، صدقنا، أنها ستبقى هكذا للأبد.
لكن بعد مرور ثلاث سنوات، بالكاد بدأت تتحرك، تقلب جسدها ببطء وثقل، ثم في الرابعة والخامسة بدأت بالزحف، ثم المشي. أما النطق، فهي حتى اليوم وبعد أحد عشر عاماً لم تجده، إنها كطفل في سنواتهِ الأولى يتحدث بكلمات متلعثمة “بابا”، “ماما”، وفي أحيان أخرى تقول كلمات غير مفهومة، لكنها أصبحت لغتنا الخاصة بالتواصل معها. وعقلها هو الآخر بطيء النمو، وقدراتها الفكرية محدودة، وكل شيء في حياتها بطيء ومتأخر.
لم يقتصر التأخر الفكري لدى فاطمة على اللغة، بل كان واضحاً في سلوكياتها، اليومية، لاسيما في سنواتها العشر الأولى، حين بدأت بالمشي، وبدأ قلقنا يزداد.
لم تكن تميز الخطأ من الصواب، ولا شعور الأمان من الخطر، كنّا نخاف أن تمسك السكين وتظنها لعبة، أو أن تتناول الأدوية ومواد التنظيف دون وعي، وقد تغادر البيت، وتضيع في الشارع دون أن تميزنا عن الغرباء.
في إحدى المرات غابت عن أعيننا للحظات فقط، أخذنا نفتش البيت عنها في كل زاوية، وكل غرفة، ننادي باسمها مراراً دون أثر لها، خرجنا وقت الظهيرة، نبحث عنها في الشوارع والمحلات القريبة، أصابنا الهلع والخوف لاختفائها، ولحسن الحظ، عرفنا لاحقاً أنها اختبأت تحت السرير وهي تلعب وقد أخذها النوم.
ولم تكن قادرة على الاختلاط بالأطفال، ولا فهم قواعد ألعابهم وسلوكياتهم، وبالطبع، لم يفضلها أحد منهم كذلك!
ومع ذلك، فبالنسبة لنا نحن إخوتها كانت محبوبة جداً منذ ولادتها، وكنت أشبّهها بالجرو الأليف الوديع الهادئ، الذي يود الشخص منا احتضانه واللعب معه، تحبهُ بالفطرة الطفولية والعفوية، وتود أن تحميه بقلبك، وتهبهُ أعز ما تملك.
ومع أني كنت صغيرة حينذاك، وأنظر إليها ببراءة محاولة إيجاد صلة تجمعني بها، دون أن أعي أو أهتم بما يفكر به الآخرون، فأنا على عكس والديّ، كان ينتابني الفضول لمعايشة أخت مختلفة، كنت أستمتع بالنظر إليها وحملها.
وبعد أن بلغت فاطمة الحادية عشرة، صرت أجلس برفقتها في حديقة المنزل لساعات أُعلّمها الألوان، أعلمها “الأحمر لون التفاحة”، “الأزرق لون السماء”.
ثم في اليوم التالي أسألها “وين الأحمر فاطمة؟” فتشير إلى كوب الشاي الأبيض.
“واللون الأزرق وينه؟” فتشير إلى الأشجار في الحديقة.
ولم يتوقف اختلافها عند نسيان الألوان وصعوبة الحفظ، بل امتد إلى اختيار الملابس أيضاً، فبات أمراً طبيعياً بالنسبة لنا أن تدخل فاطمة الغرفة فجأة وهي ترتدي” قمصلة وبلوزة” في منتصف تموز! أو أن تصر في الشتاء على ارتداء “البرمودة” المفضلة لديها مع “القمصلة الوردية”.
وحتى اليوم، بعد بلوغها السادسة عشرة، لا نتركها بمفردها في المنزل أبداً، ولا تغيب عن أعيننا ولو لثانية.
نتأكد دوماً من اعتنائها بنفسها ونظافتها الشخصية، نذكرها بأوقات تنظيف أسنانها بالفرشاة، وروتينها الليلي للعناية ببشرتها، وأقص أنا أظافرها، وأمشط شعرها.
لكن الأمر ليس صعباً علينا فحسب، بل يصعب عليها هي نفسها، ففي الكثير من الأحيان لا تجيد التعبير عن حاجاتها النفسية، فتلجأ إلى الاعتزال في الغرفة، وتبدأ بالبكاء دون سبب واضح، وبعد التحقيق معها بألف احتمال، نكتشف أن السبب قد يكون نبرة غاضبة وُجهت إليها دون قصد، أو صوتاً مرتفعاً قد أزعجها.
فاطمة، ابنة الأحد عشر عاماً، ما زالت في داخلها طفلة رقيقة حساسة، لا يتجاوز استيعابها استيعاب طفل بعمر خمس سنوات.
“حلوة مو مسكينة”
في سنواتها العشر الأولى، كان أكبر هاجس للعائلة أن تغيب عن أنظارنا ولو لثانية واحدة، كان والدي يخشى أن تتعرض للاستغلال أو الاعتداء أو الخطف، خاصة مع انتشار شائعات آنذاك عن استهداف الأطفال من ذوي المتلازمات لغرض المتاجرة بهم، أو لاستغلالهم في التسوّل على تقاطع الطرق.
فاطمة لا تغادر المنزل إلا نادراً، ربما مرة أو مرتين في السنة، غالباً ما تكون زيارات لطبيب أو من أجل إجراء معاملات رسمية ضرورية.
وجدنا أن جدران الغرفة الصامتة أرحم بها من البشر في الخارج، وأن البيت أكثر اتساعاً لها من كل الأماكن خارجه.

اعتدت في السنوات الأخيرة على ممارسة المشي ليهدّئ من تشتت أفكاري، لذا قررت مرة أن أصطحب فاطمة برفقتي للتنزه في مكان قريب من منزلنا، حيث الساحات الرياضية الواسعة، كنا نتجنب المارين، لكن سرعان ما التهمتنا الأنظار. إحدى النساء، التي لا تجمعنا بها أي صلة ضايقتنا بالتحديق المستمر الصامت طوال الوقت وبنظرات مسمومة وابتسامة شفقة، كأنها اكتشفت سراً عظيماً، أن من تراها أمامها طفلة مصابة بمتلازمة داون.
شعرتُ بالقرف، ووددتُ أن أفتعل شجاراً و”أطيح حظها”، في حين ما زالت مستمرة بالتحديق بلا خجل ولا حياء، لم يكن بيدي حيلة سوى مواجهة الأمر بالصمت ثم ترك المكان والابتعاد، فلا جدوى من الجدال معها!
لم يكن هذا أول موقف، وبالتأكيد ليس الأخير، ولم يقتصر الأمر على الخروج من المنزل فحسب، بل حتى في المنزل، إذ لم تسلم فاطمة من نظرات الشفقة وشعور الدونية من الزوار، إذ تكرر الأمر ذاته في الجمعات العائلية، التي يتواجد فيها الأقارب. في إحدى المرات تفوهت إحدى القريبات، دون مراعاة لنا أو لفاطمة، قائلة: “خطية هاي البنية مريضة…مسكينة”، ساد الصمت لكني اعترضتها بقولي: “لا فطومتنا حلوة ومو مسكينة”.
ومع أن عائلتنا اعتادت على سماع تلك التعليقات، إلا أن جملاً مثل “عدهم بنية منغولية” أو “بنتهم خطية معوقة”، ما زالت تُدمع عينَي والدي.
لا أحد يدرك أثر تلك الكلمات جارحة فينا، نحن عائلتها التي نحبها ونرفض أن توصم بالشفقة وأن يُحكم عليها بالنقص، بلا رأفة، وبلا رحمة، فقط لأنها ولدت هكذا.
والدي ووالدتي اللذان وجدا صعوبة كبيرة في التعامل مع فاطمة وحتى في تقبلها في السنوات الأولى بعد ولادتها، تحولا في التعامل معها كثيراً، وإن كان التحول بطيئاً وتدريجياً، فمن التعامل معها بالقهر والرفض إلى القبول والألفة متبعَين غريزة الأبوة والأمومة مستعينَين بعقيدتهم الدينية التي طالما أعانتهما على تجاوز الأزمات، يرددان دائماً: “لعل لنا فيها أجراً.. لعل تربيتها تعويضٌ وشفاعة لنا في الحياة الآخرة”.
براءة فاطمة التي لا تفارقها زادت مع الوقت من عطفهما نحوها، يحرص والدي عند عودته من العمل على الجلوس بجانبها وتوفير تبريد وتهوية مناسبة في صيف العراق اللاهب، ودفء في برد الشتاء، لأنها حساسة جداً لتغيرات المناخ، وكان يصرّ على أن تنام إلى جوارهِ كل ليلة ليطمئن عليها.
أما والدتي فقد باتت فاطمة رفيقتها في البيت، لا تغيب عن نظرها، تطعمها، تبدل ملابسها، تنشغل بالطبخ والتنظيف لكن تظل فاطمة معها، مثل عينيها، جزء منها، إما تلهو بألعابها أو تجلس أمام التلفاز لساعات طويلة لتشاهد قناة “سبيستون”، لا تمل من كرتون “فلونة” و”الدب المحبوب” رغم أنها لا تفهم الكثير مما يعرض، إلا أنها كافية لشغل وقتها.
حاولنا أن تكون للطفلة حياة شبه طبيعية أسوة بغيرها من الأطفال، ليس فقط في البيت بل في الخارج أيضاً.
لكن لم تقبلها أي مدرسة، لا الحكومية ولا الأهلية، التي أصلاً ترددنا كثيراً حينما فكرنا فيها، ففاطمة لا تشبه باقي الأطفال ولا تجيد الاختلاط ولا الحديث معهم! استيعابها العقلي لا يتجاوز استيعاب طفل في الخامسة من عمره، وهذا التخوف تشاركنا بهِ إدارة المدارس، الخوف من تعرضها للتنمر أو النبذ بين الأطفال في حال دمجها معهم.
أخبرنا مدير إحدى المدارس الأهلية بأنه يمتلك صلاحية مطلقة من وزارة التربية لتسجيل الأطفال من ذوي المتلازمة، لكنه يفرض شرطاً أساسياً، ألّا يقلّ عدد المسجلين عن عشرة طلاب من ذوي المتلازمة ليتمكن من افتتاح صف خاص بهم، وتوفير كادر متخصص في التربية الخاصة، دون دمجهم مع بقية الطلاب، لكونهم بقدرات استيعابية مختلفة، مردفاً أن كلا الشرطين لا يتوفران، وعندما اعترضته متسائلة: “معقولة ما توصلكم هيچ حالات تسجيل لطلاب من ذوي المتلازمة؟”
سكت قليلاً، ثم أجابني بمنتهى الصراحة: “إحنا مجتمع شرقي، محد يرضى يسجل ابنه، لأن يشوفه عيب، ويتعرض للشماتة والتنمر وحتى الاحتقار إذا عرفوا عنده طفل منغولي! فضلاً عن أن توفير كادر تربية خاصة لهم يتطلب رواتب، وأني ما أكدر أدفع راتب كادر كامل على طالب أو اثنين”.
نظرياً، ممكن لفاطمة أن تكون ضمن إطار مدرسي يخرجها من عزلة البيت ويجمعها مع أطفال من متلازمة دوان، لكن المجتمع والدولة لا يجتهدان من أجل تحقيق هذه المسألة التي هي حق في القانون للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا الحال ينطبق على العراق عامة، إذ لا توجد مدارس خاصة لذوي المتلازمة، ولا مراكز تعليمية أو تأهيلية في المحافظات، هناك عدد محدود جداً في العاصمة بغداد.
وبالنتيجة يصبح أطفال متلازمة داون فئة منبوذة مجتمعياً، مهمشة ومحرومة من التعلم والفرص في الحياة، مع تفاوت شدة الأعراض لديهم، يتحملون عبء جهل المجتمع، وتقصير الدولة، ومسؤولية كونهم ولدوا بمتلازمة لا ذنب لهم فيها.
أخت صغرى على طريقتها
رغم عزلة فاطمة، وحدود عالمها الذي ينتهي عند بوابة المنزل منذ ولادتها، فإنها تملأ المكان بضحكاتها المفاجئة وبكائها، اعتدنا على وجودها، تحولت من عبء وسبب للحزن، إلى بهجة العائلة ومصدر سعادتها، بشعرها الأسود القصير، وملامحها البريئة، وجسدها الذي بدا يقوى ويزداد جمالاً.
كلما تقدمت فاطمة في العمر، ازددتُ يقيناً أن تماسك العائلة يعود لوجودها بيننا، يجمعنا شعورٌ بالتعاطف والمسؤولية نحوها وقد شهدنا مراحل حياتها وهي بدورها شهدت مراحل حياتنا، كلنا كبرنا، هي ونحن، وقد قدمت لنا عناية خاصة على طريقتها.
ذاكرتي ممتلئة بمشاهد يومية دافئة برفقتها، ففي الأيام الحزينة التي مرت عليّ، كانت تجلس بجواري بصمت، وتربت على شعري بمنتهى الحنان. والليالي التي داهمني فيها شعورٌ باليأس والمرض، كانت الوحيدة التي تلاحظ حزني وتسأل بكلماتها المبعثرة “كوكي شبيك؟” والمرات التي خضت فيها جدالاً عائلياً، ورفعت صوتي، كانت تنتظرني حتى أهدأ، ثم تقترب دون أن تتكلم، كأنها تشاركني الصمت أيضاً.

صوت ضحكاتها يملأ منزلنا، روحها تحب الفن والتلوين، وبالفطرة باتت ترسم. تمضي وقتاً طويلاً برفقة ألوانها وأوراقها، رغم أنها لا تجيد الرسم، لكنها تكتفي بتلوين الورق بعشوائية وتمزج الأخضر بالأصفر.
كما أنها تمتلك ذوقاً موسيقياً شرقياً بامتياز، لطالما أثار فضولي، فقد كانت تسمع أغاني كاظم الساهر في بادئ الأمر، رغم أنها لا تعي كلماته ولا تعرف حتى لفظها، ثم بمرور الوقت أصبحت تفضل أغاني ساجدة أكثر، لترقص على ألحان أغانيها لساعات بلا ملل ولا كلل، ومؤخراً تصدرت أغاني الفنان المصري محمد حماقي قائمة أغانيها المفضلة، فتسمعها بلا توقف.
أراقبها وأقول لا بد أن تكون ممتلئة بالحياة في داخلها، وكأن الخارج لا يعنيها. بطبعها تحب الغناء والرقص الشرقي، وتستمتع بهما كثيراً، وتمارسهما وكأنهما طقوسها الخاصة بالمتعة في عالمها الذي يخلو من البشر والأصدقاء.
الأيام برفقتها كنزهة بين الأشجار، غنينا معاً، وطبخنا الكثير من الوصفات والمعجنات معاً، ورسمنا معاً، وضحكنا كثيراً في عالمنا الخاص بعيداً عما يرى ويعتقد الآخرون.
لقد كانت أعظم هبة مُنحت لنا، وهي -على عكس ما يظنه قطاع واسع من المجتمع بوعيه المحدود- محل امتنان لنا.
“من سيكون عوناً لها بعد مغادرتنا هذه الحياة؟ حين يتزوج إخوتها ويستقلون في حياتهم الخاصة، من سيتولى رعايتها والاهتمام بها؟”
لا يتوقف والديّ عن التفكير بمستقبل فاطمة عندما تكبر، تخيفهما فكرة التقدم في العمر، شعور بالمسؤولية يعتريهما لأنها ستكون دوماً بحاجة إليهما، دوماً بحاجة لمن يمنحها الأمان كما فعلنا.
من بعدهما سيعتني بها؟ من بعدنا سيرقص مع فاطمة؟