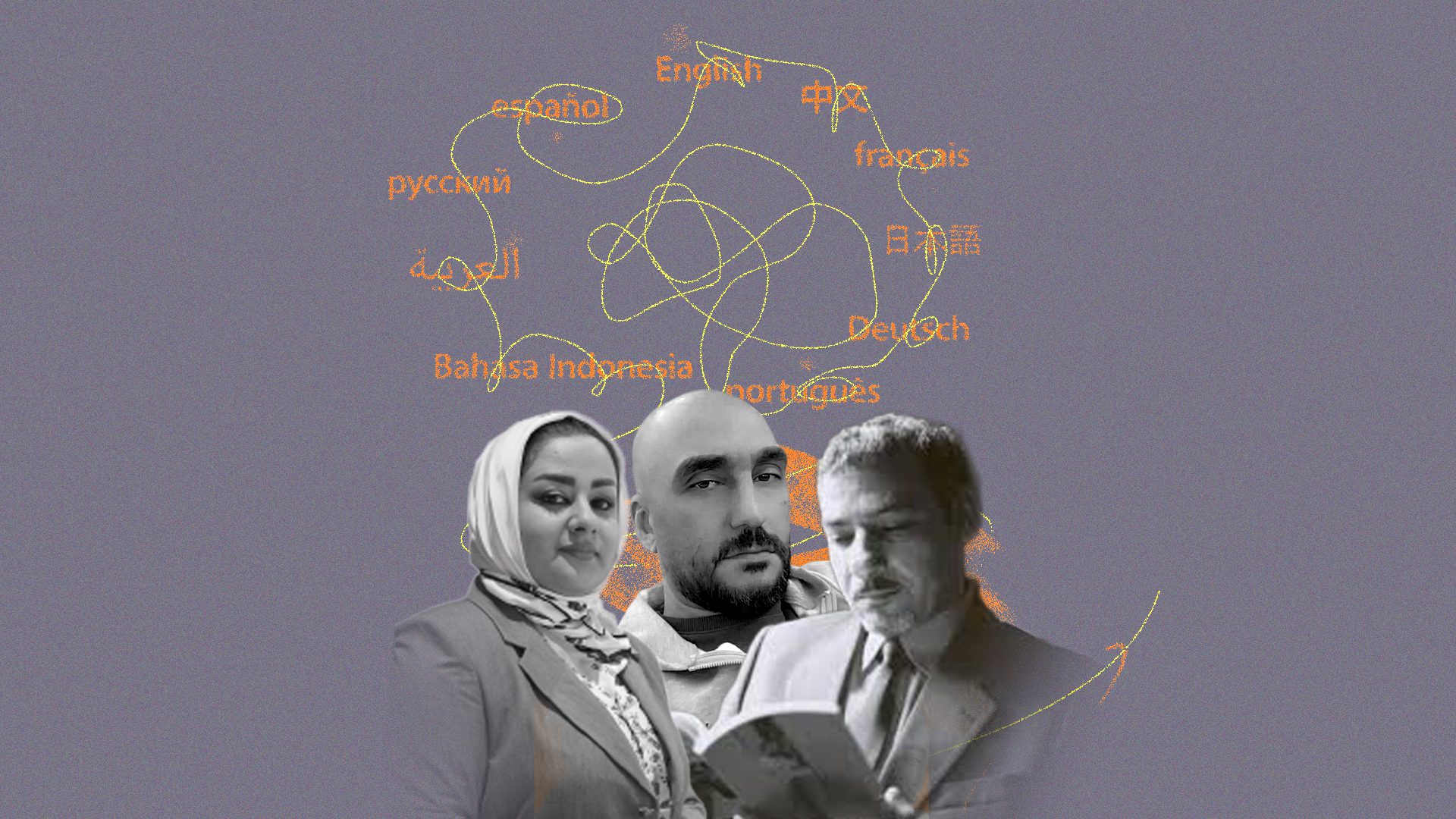بدأتُ بالترجمة عندما كنت طالباً في المرحلة الثانية أو الثالثة من دراستي للغة الإسبانية في جامعة بغداد، حيث عثرتُ على لقاء مع رافائيل ألبرتي في نشرة لمعهد ثربانتس في بغداد، الذي كنت أتردد عليه وعلى مكتبته كثيراً، ففرحتُ لأنني فهمته كله عند قراءته، ولذا سارعت إلى ترجمته، وبعثته إلى إحدى الصحف الرئيسة آنذاك، ففاجأتني سرعتهم في نشره ومطالبتي بالمزيد من الترجمات، ومن يومها لم أتوقف عن الترجمة ممارسةً ودراسةً وتدريساً، لكنني، ولأن مشروعي الرئيس هو الكتابة، كنت ومازلت أضع الترجمة في المقام التالي لعملي، أي أن الأولوية لأعمالي الأدبية، وهذا ما جعلني أنتج في الترجمة أقل مما أتمنى وأستطيع.
فبالنسبة لي، لا شك أن الكتابة أعمق من الترجمة، لأن الكتابة هي الأصل، والترجمة صورة مُستنسَخَة لها، تحاول أن تكون شبيهة بالأصل قدر الإمكان، ولكنّ ذلك مستحيلاً، فلا وجود لترجمة تتطابق مع النص الأصلي تماماً، مثلما أن الصورة أو المرآة لن تكون هي الأصل أبداً.
لكن الترجمة بحد ذاتها، عمل مهم ونبيل ونافع وشريف وممتع وجميل، يستحق الامتهان وتكريس العمر له، وتجربتي في الترجمة كانت مهمة في حياتي، تعلمتُ منها الكثير على صعيد الكتابة، كالأسلوب، وثراء اللغة، ودقة اختيار المفردات، وإعادة بناء الجملة، ومراعاة الدلالات، وتعلُّم القراءة الدقيقة وغير ذلك.

تجدر الإشارة إلى أننا اليوم قد تجاوزنا الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه المترجمين سابقاً، والتي كان من بينها صعوبة النشر، وقلة المردود المادي، وندرة القواميس وما إلى ذلك. فبالعكس، أصبحت الترجمة بوصفها عملاً كتابياً أسرع في النشر وأنفع مادياً من الكتابة الإبداعية. تبقى هناك صعوبات قد تخص طبيعة عمل المترجم نفسه، فمثلاً عندما أُترجم نصوصاً عربية إلى الإسبانية، أكتشف أن هناك كلمات كثيرة لا معنى لوجودها، زائدة ولا تخدم النص، فهي زخرفة أو ثرثرة يمكن الاستغناء عنها. ومن الصعوبات أيضاً، أن العربية أكبر وأغنى من حيث عدد الكلمات، ففيها أكثر من عشرة ملايين كلمة، بينما الإسبانية لا تتجاوز مئتي ألف كلمة، وهذا يعني أن هناك ملايين الكلمات العربية التي ليس لها مقابل بالإسبانية، وربما لهذا كان عدد الأعمال التي ترجمتها إلى العربية من الإسبانية هو ضعف ما ترجمته من العربية إلى الإسبانية. هذا عدا كون العربية هي لغتي الأم والأحب، أما عندما أُترجِم من الإسبانية إلى العربية، أجد أنني أفقد الكثير من شِعرية الإسبانية ودلالاتها الثقافية الخاصة المختلفة عما في القواميس، وهنا على المترجم أن يكون عارفاً جيداً بثقافة اللغتين، ومعايشاً لهما، وليس عارفاً باللغتين فقط. والصعوبة الأخرى هي سؤال المترجم الدائم لنفسه: هل يحافظ على دقة ترجمة النص حرفياً أم يطوّع أسلوبه لصالح اللغة التي ينقُل إليها؟ وفي كل هذه الحالات المذكورة، تقع المسؤولية على كل مترجم أن يقرر كيفية التصرف، حسب رؤيته.

حلمتُ في مراهقتي أن الشاعرة فروغ فرخزاد تهديني حذاء شفافاً بلون مائل إلى الزهري، أشبه بالذي ارتدته سندريلا. فروغ كانت أول شاعرة تمسك بيدي لأدخل عالمها الشعري، جعلتني أخطو في طريقٍ عَبّرتْ عنه ذات مرة بقولها: “الجميعُ يخشى، الجميعُ يخشى، لكنْ أنا وأنتَ.. اختلطْنا بالضوءِ.. بالماءِ والمرايا”. وهكذا من خلال الترجمة والشعر منحت الحب أكثر مما تلقيته، وصرت شيئاً سيّالاً يمكنه أن يدخل بين سطور مؤلف حقيقي، أشعر وأتألم معه، وأكتب على لسانه وأنا الشاهدة الوحيدة، شاهدة ينساها في الغالب القارئ، لأنها الوسيط لا المالك.
لم يكن صعباً عليَّ أن أتصور نفسي ملمة بالفن، إذ ولدتُ محاطة بعائلة محبة له، وكنت على يقينٍ، كلما أخذت خلسة دفتر مذكرات أخواتي، أو الكتب التي تواظب على قراءتها أمي، أنني سأجد ضالتي هنا أو هناك، شيئاً أبحثُ عنه ولا أعرف ما هو، لكنه جزء مني، هكذا أستشعره، شيئاً يشبهني ولا يحتاج سوى التعبير، ثم لاحقاً، عبّرت عن ضالتي في الأعمال الفنية، ثم كتابة الشعر.
بدافع المتعة حولتُ كل نص أحببته إلى الآخرين، وكنت أقرأ قراءة مكثفة باللغتين العربية والفارسية، ما دفعني إلى نقل ما أقرأه بالفارسية إلى القارئ العربي، وحرصتُ كل الحرص على أن أحافظ على جمال النص الأصلي عند نقله إلى اللغة الأخرى.
وأتساءل هل وُفقتُ في ذلك؟ لقد بذلت جهوداً مضاعفة، ليلاً ونهاراً، للحفاظ على روح النص الأصلي ونقله كما هو.
تعرفت خلال هذه الوقفات على حقائق كثيرة، منها السعي لأجل الفن الحقيقي، وهو لغة عالمية، لا يعبَّر عنها بالحروف والأبجديات، ولا بالنحو والصرف، بل بلغة الطير ومنطقه، وبلغة قلوب المحبين، وبريق عينَي طفلة عائدة من المدرسة، هذه هي لغة الشعر، يفقهها من تُحرِّك مشاعره غيمة مارة في سماء نيسان، أو رائحة البطيخ في الصيف.
عندما عملت بالترجمة، أصبحت شريكة في كتبٍ كُتبت قبل مئة عام، أستطيع أن ألمس روح قارئ يبعد عني آلاف الكيلومترات، ويمكنه أن يشعر بي، حتى لو كنت أعيش في قبو.
اخترت كتباً لأترجمها دون الاهتمام بسوق الكتب، أحببت تقديم كتب كتبها أشخاص في “الأزمنة الذهبية”، كما أسميها، وبالطبع وجدت بينهم وبيننا رابطاً حقيقياً، هو الفن. هذا المفهوم الذي لا يشيخ، بل كلما تعتق صار أثمن وأغلى، الذي ما استطاع الذكاء الصناعي تدبره، ولا يمكن تزويره، إنه بصمة إنسانية خالصة، ويعبر شاملو عنه بقوله: ” في غياب الإنسان العالم بلا هوية، والفن شهادة على الحقيقة، وضوء يترجم الفجيعة”.
واليوم تحولت من تلك المراهقة إلى شاعرة مترجمة، ممتنة لذائقتي في قراءة الكتب أولاً، ولكبار المترجمين الذين علمونا فن الترجمة بوصفها فنّاً قبل كل شيء، ومنهم المنفلوطي. كما أنني ممتنة لمعلمينا، مثل آدم فتحي، وعلي مصباح، وصالح علماني وغيرهم من مترجمي الحقائق.

“ما نحن إلا كاذبون محترفون نأمل أن نخدم الحقيقة”.
عام 2017، تحديداً في شهر آب، رأيت في إحدى مجموعات الفيسبوك أحد الأشخاص يبحث عن ترجمة لأحد الأفلام الكلاسيكية الرائعة، الفيلم كان من كتابة المبدع أورسن ويلز، ومن بطولته وإخراجه، يتناول فن الخداع والتزوير في كافة المجالات.
فكّرت، لمَ لا أغامر وأحاول ترجمة هذا الفيلم؟
وبعد البحث والتقصي عن طريقة ترجمة الأفلام بدأت بترجمته، وفي غضون عدة أيام انتهيت من الترجمة.
كانت عبارة “ما نحن إلا كاذبون محترفون نأمل أن نخدم الحقيقة”، خاتمة لفيلم “F for fake”، الذي تحدث عن أشهر المزورين في التاريخ، في مجالَي الرسم والسحر، وعكست العبارة جانباً من عمل هؤلاء السحرة، يعترفون فيه بلجوئهم إلى الخداع والتحايل، أما بالنسبة لي، فقد كانت هذه العبارة كتميمة سأبدأ بها عالم الترجمة.
فبعد أن لاقت ترجمتي ردود فعل إيجابية، قررت دخول مجال ترجمة الأفلام، رغم أنه لا قوانين تحكمه، أو تحمي حق المترجم، كما أنه دون أجر، إلا إذا تعاقد المترجم مع شركة إنتاج معروفة، أو منصة إنتاج، مثل منصة “نتفليكس”.
لكن هذه “المهنة” أو “الهواية” بالنسبة للمشاهدين مهمة جداً، فأغلب شركات الإنتاج العالمية لا توفر الترجمة باللغة العربية لأي فيلم، فيتولى العديد من المترجمين هذه المهمة، وإن كانت بلا مردود مادي وبلا قوانين.
كما أن معظم الأفلام تنقل ثقافات الشعوب وتقاليدها، لذا من الضروري الاطلاع عليها لمعرفة كيف يعيش الإنسان في هذا العالم، لذا فإن مهمة المترجمة تلزم المترجم بنقل الصورة التي يعكسها الفيلم بكل مصداقية وثقة.
وعلى مدار هذه السنوات، واجهت شخصياً الكثير من العوائق والصعاب، رغم الجانب الإيجابي، سواء من المديح الذي أتلقاه من الكثير من محبي الأفلام ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كنت أواجه أحياناً الانتقاد كوني أبتعد عن الترجمة الحرفية لبعض الجمل التي تختلف من ثقافة لأخرى، وتعتبر “تابو” يمس الآراء لأسباب أخلاقية في الدرجة الأولى.
لكن لا يوجد مجال يخلو من النقد، فشجعني الدعم المستمر، سواء من المشاهدين أو من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، على مواصلة عملي في مجال ترجمة الأفلام، وكان للدعم الأثر الكبير في استمراري.
من الأسئلة الشائعة التي كانت تطرح عليّ باستمرار: “كم تتقاضى على الفيلم الواحد؟”
والإجابة دائما كانت تكون “مجال ترجمة الأفلام مجاني ولا نتقاضى أي أجور على الفيلم الذي نترجمه”، فالمردود الدائم من هذه الهواية هي المردود المعنوي، ولا أنكر فرحتي عندما يذكر شخص فيلماً كنت قد ترجمته ويمتدح ترجمتي، أو يشير إلي على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأمور لها الأثر الكبير نفسياً ومعنوياً، وهي تخفف من ألمي البدني بسبب الجلوس لساعات متواصلة أمام جهاز الكومبيوتر، بالإضافة إلى صعوبة لغة بعض الأفلام التي أقوم بترجمتها، والتي تحتاج إلى تركيز ذهني، فجوهر الترجمة يكمن في أمانة نقل المعلومة.
بعد مسيرة استمرت منذ العام 2017، ولا تزال مستمرة ولابد أن تنتهي يوماً، أفتخر بكوني ترجمت وساهمت في ترجمة عدد كبير من الأفلام تجاوز المئات، وهذا ما ترك انطباعاً لدى المشاهد بأن أي فيلم من ترجمتي هو فيلم جيد ومصحوب بترجمة دقيقة وخالية من الأخطاء، رغم أن الوقوع في الخطأ عادة بشرية ولابد من أن نقع فيه بين الحين والآخر.

في عيادة الطبيب “موتو”، عندما كنت في العاشرة، نمَت أول بذرة لي في الترجمة، والفضل يعود لعمتَيَّ صبيحة وبثينة، فرغم أنهما كانتا تجيدان الإنجليزية جيداً، إلا أن تفضيلهما اللغة العربية جعلني أترجم كلام الدكتور موتو إلى عمتي بثينة، من أجل الدقة التامة. وكان ذلك سهلاً، فقد كنت أتحدث العربية (العراقية) والإنجليزية بالطلاقة نفسها، فقد نشأت في الولايات المتحدة.
بعد عشر سنوات، كان الحدث الكبير، ففي مستشفيات جامعة آيوا عُينت مترجماً طبياً لكبار السن السودانيين، الذين وصلوا آنذاك لاجئين. في تلك اللحظة بدأت أفهم أن الترجمة حرفة ونوع من الأعمال أيضاً، فليست الترجمة لعائلتي وعمتي فحسب، بل لعالم أكبر وأوسع، وفهمتُ أني أصبحت مترجماً.
أما الترجمة الفنية التي تتطلبُ ذائقة إبداعية، فقد اختبرتها في ورشة عمل جمعت الكُتّاب في ولاية آيوا، حينما زارتها الكاتبة الفلسطينية زهية كندوس “Zahiye Kundos”. لقد تلذذتُ بالإبداع، إذ كانت قصصها القصيرة مقنعة ومضحكة وسريالية بعض الشيء، بترجمات لا نهائية.
ترجمت بضع قصائد وقصصاً قصيرة مختلفة. وبعد رحلة ترجمة الأدب، ترجمتُ لوفد من زعماء النقابات العراقية الزائرين لنيويورك عام 2009، كان ذلك جوهر مشروع كتابي الأول، الذي ضم مقابلات طويلة تترجم أحلام الناشطين العراقيين الرؤيويين، بطريقة تجعل القراء الإنجليز يتأثرون بها، وتدفعهم إلى التضامن والعمل.
وها أنا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أترجم المواد التي أشعر أنها الأكثر إثارة للاهتمام، وتلح لأخرجها إلى النور بلسانٍ مغاير.
إن إبقاء صدى الصوت الأصلي في الترجمة كان مهمتي الأولى، والتفكير أيضاً بأنها قطع جديدة بلغة جديدة توازي القديمة.